ظننتني فرغت من استعادة "شذراتٍ وخواطرَ ومواقفَ" أطلقتها، عبر السنين، حدَّدت فيها رؤيتي إلى جوهر الكتابة، فلم أفرغ... وبعد حلقاتٍ ثلاث، إليكم الرابعة، والبقية تأتي.
جملة أسئلة طرحَتها عليَّ طالبة زارتني في مركز عملي الإذاعي، ذكَّرتني بها ذات ندوة: هل من شروط الصحافة المكتوبة أن يُجيد الصحافي كتابة الشعر؟ وهل من الأفضل ألَّا يكتب من لا يتقن قواعد اللغة حتّى لا يطيحها؟ وما أكثر شيء أشتاقه في طفولتي ويسكن بالي ويتملكني وله تأثيره في مسار حياتي دائمًا؟
الشعر في نظري، روحه على الأقل، قلت لتلك الصبية الملحاحة، أساس كلِّ شيء، لأنه التكثيف والتلميح والجمال. فما بالك في الصحافة التي نشأنا على أقلام أدبائها وتعلَّمنا وتثقَّفنا، لأنهم أتوا بالينابيع إلى شفاهنا. ومن لا يتقن قواعد اللغة، يُعاب عليه ذلك. ولكن يعاب عليه أكثر إذا لم يتقنها، ولو رويدًا رويدًا، ونصيحتي له ألَّا ينشر قبل أن يتأكَّد له خلوُّ لغته من الأخطاء. إلَّا من يظنُّ نفسه أبا سيبويه... أو أستاذه، علمًا أنَّ سيبيويه ليسَ إِلَّا تلميذ "ابني": يونس بن حبيب...
أما طفولتي فلا أشتاق إليها، لأنها كبرت معي، وما زالت طفلة. ولكن أفتقد رائحة أمي، ونظرة أبي المهيبة الحنونة.
استوقف عنوان ديواني، بالمحكية اللبنانية "يمكن ع بال الغيم شربة مي"، الذي صدر عام 2020، وحالت الظروف دون توقيعه بعد، كثرًا. فسألني أحدهم عما قصدت به. قلت إنه نابع من صورة مرت ببالي وأنا أرقب الغيم الكثيف. سألتني، ذات مرة، لعل الغيم يحتاج إلى جرعة ماء، هو الذي يهدي إلينا ماءه لنبقى على قيد الحياة. عددت الغيم أرقى إنسان.
وأشعلت آنسة مثقفة في مناخًا أفتقده منذ أكثر من عشرين عامًا، حين سألت: ربيت في بيت الكلمة فيه ملكة، إلى أيّ مدى تأثّرت بوالدك على الصعيد الشعري؟
ردَّ عليها الدمع والغُصَّة أن والدي، بلون عينيه العسلي، وبشاعريته، وبقلبه وجبينه الأيقونيتن، هو كلِّي غيرُ منتَقصٍ منه إلَّا غيابه... وقد غاب انسلاخًا عني، وووري وأنا عنه بعيد في "سابع سجن". ولعلَّ تلك اللحظة هي جرحي الوحيد الذي لا يندمل. أثر والدي فيَّ أنه ربَّاني على الوزن والإيقاع والجمال واللُّقيَّة الجميلة التي قال فيها سعيد عقل حين قدم لديوان أبي "كلُّن يومين": "إذا كان الشِّعر لقيَّات، فأنطون يونس شاعر يُعلَّم عليه الشعر". فضلًا عن أنَّ والدي سلَّمني مفاتيح الحياة، وقال لي: خذ الحياة بقوة، ليس الكتاب فحسب.
وعلمني والدي أيضًا أن الشِّعر لا يلقن، لأن الإنسان يولد شاعرًا، أو يكون فيه شاعر خفي يُكتشف لاحقًا. وقد تقع مهمة الاكتشاف على شاعر أو على مصادفة.
واستفاضت ناشطة في المجال الثقافي في السؤال عن الفارق بين الشعر المحكي اللبناني والزجل، وبين المحكي والفصيح، وعن رأيي في قصيدة النثر "كونها لا تغنَّى بسهولة كما يغنى الموزون والمقفى"، وهل صحيح قول الشاعر مارون أبو شقرا إن الشعر يشركك في إبداع القصيدة من خلال ما يترك لك من آفاق مفتوحة، فيما يغلق الزجل عليك كل أفق الخيال لكثرة السرد والعادية واللادهشة؟ فبمن أشبه نفسي؟ وأين أقيم إذا كان الشاعر الراحل عصام العبدالله يقيم في المقهى لأنه مقيم في حريته؟

عن كثيف السؤال وتشعبه، أجبت أن صانع الشعر المحكي مثلما وصل إلينا، ما هو إلَّا الكبير سعيد عقل. لكنه لم ينشر شعره المحكي في ديوان إلَّا متأخرًا، لأنه كان يرغب في أن تكتمل تجربته تلك بحرف خاص. لذا سبقه إلى النشر ميشال طراد، عام 1951، في "جلنار"، الذي وضع سعيد عقل مقدمته. لذا يعد طراد الرائد، علمًا أنَّ عقل نشر بعده بعشر سنوات تحفته بالمحكيَّة اللبنانية "يارا".
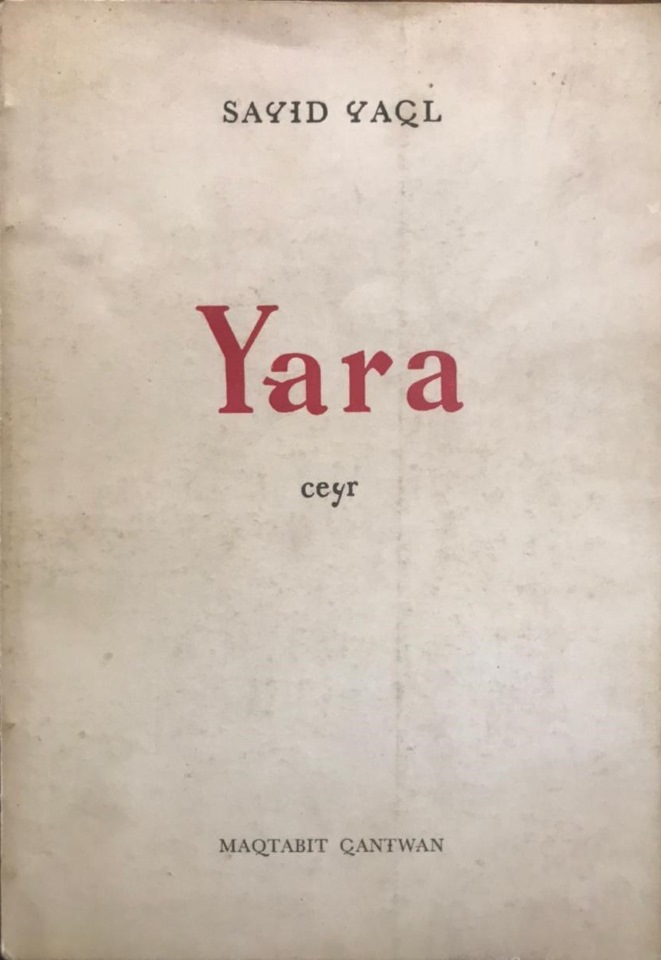
وفي دراستي عن الزجل التي نشرتها في كتاب مشترك مع الشاعر مارون أبو شقرا، تحت عنوان "الشَّاعر والزَّجَّال والشِّعر بينهما"، استشهدت بالعلامة عبدالله العلايلي الذي كتب في دراسة له أنَّ الشعر المحكي واكب وعاصر الشعر الفصيح مذ كانت العرب. وكذا هي حال الشعر المحكي اللبناني.
أما صديقي الشاعر أبو شقرا فلم يظلم شعر الزجل حين أفصح عن رأيه، لأن ثمة قصائد زجلية ما زالت تفتح النوافذ على آفاق لا حدود لها ولآمادها. لكنه عبَّر عن هذا الموقف بتناوله طقوسية الزجل، والحماسة التي تثيرها في المتلقي، والارتجال الذي يطغى عليها، أو الاستعجال الذي يفرض نفسه على الزجال، خصوصًا حين يقدم عشرات الحفلات ويلبي عشرات المناسبات.
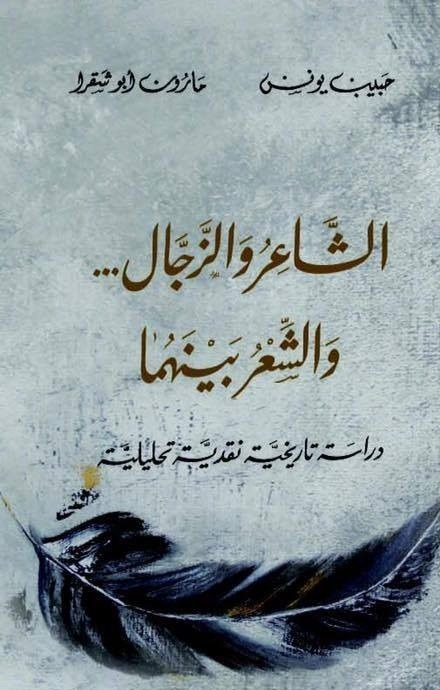
وأظنُّ أن الشعر المحكي اللبناني فرض نفسه في مساره الجمالي والعقائدي والفلسفي والاجتماعي واللغوي. وإذا وضعت سعيد عقل خارج التصنيف، أستطيع أن أحدد المسار المتصاعد بالشعراء: عبدالله غانم، ميشال طراد، موريس عواد، جوزف حرب. وجميعنا ما زلنا ندور في فلك تجاربهم الرائدة، فضلًا عن الأخوين رحباني اللذين أعدهما فنانين شاملين، تلحينًا وعزفًا ومسرحًا ورؤيا، لا شاعرين فحسب.
وأضفت أنَّني أحبُّ كلَّ كتابة جميلة، وإن كنت لا أوافق على تسمية "قصيدة النثر" أو حتَّى "القصيدة بالنثر"، لسبب أساسٍ وجوهري، ومن دون أن أفصِّل وأستطرد، لأن النثر لا يقلُّ جمالًا عن الشعر.
وإذا كان من تشبيه، فإني أحبُّ أن أتشبَّه بشاعر لم يولد بعد، لأنَّني، كما سبق أن أسلفت، جميع الشعراء وفي الوقت نفسه ولا أيُّ واحد منهم. لعلَّني أتمنى الآن أن أبقى أشبه نفسي. وأنا كعصام... أقيم على سطر نمل، وفي شفة فنجان قهوة مرة. وأقمت، ذات شباب، في تدلِّي شعرِه على كتفيه، كما شالٌ على كتف حبيبة.
وطالعني رجل حكيم، شاعر ورئيس منتدى، بسؤال متى أضع نقطة آخر السطر؟ وهل غضبت مرة من نقدٍ وُجّهَ إليَّ؟
أجبته لا نقطة على آخر السطر، كما كتب جوزف حرب نقلًا عن حكيم صيني، بل فاصلة، لأن لا انتهاء لشيء، وكلما أنهيت بكلمة انفتحت الشبابيك على كلمات. أو كما قلت شخصيًّا، ذات مقالة، الكلمة الأولى هي حواء الكلمات، والخليقة بعد مستمرة.
ثم إن أي عمل نأتي به منطلقًا من محبة، لا بد يغني ويفيد. فإذا انتقدت فلأنني أحب، لا بهدف التجريح أو الإساءة. أتقبل النقد ممن يعرف، ولست معصومًا من خطأ. لكنني أرفضه من جاهل، فيغلبني... رحم الله الإمام الشافعي.
 سياسة
سياسة




















