أتابع، في هذه المقالة، ما بدأت به من شذرات وخواطر ومواقف، تختصر رؤيتي إلى جوهر الكتابة.
ولعلَّ أكثر ما يلفت القارئ إليك موضوع الموت وما يتفرَّع منه من موضوعات، أو هو الَّذي يتفرَّع منها.
فموضوعات الموت، أو تلك المتعلّقة به من مثل الغياب والرَّحيل والفراق، حاضرة في قصائدي حضور الله والحبِّ والغزل والوطن والطَّبيعة والوجدان.
أحسُّني وأنا أنهي قصيدةً، أنَّني أنهيت بها حياتي، وأنتظر موعد الارتحال. وفي الانتظار أتمسَّك بما بقي لي من أويقات على الأرض، شاعرًا في الوقت نفسه أنَّ لي كلَّ الحياة، بين طيَّات القصيدة.
وليس مستغربًا أن أعبِّر عن حالات الموت والغياب في قصائدي، وأنا في مقتبل الشِّعر والعمر، لميلٍ فيَّ إلى الرحيل. فهذه الحالات تحوَّلت عنصرًا أساسًا قائمًا بذاته، لفت أحدَ الباحثين، فأكبَّ على دراستها لنيل أطروحة دكتوراه في الجامعة اللبنانيَّة.
وليس الموت وحده ما يجعل القصيدة تحيا، إنَّما أيضًا كلُّ خلجة صادقة فيها تَكتبُ لها في الحياة، وقلِ الخلود، بقاءً دائمًا.
الشِّعر عاطفةٌ صادقة، ترفدها الصُّورة والأسلوب واللُّغة، ويظلِّلها الجمال، لتبقى الفكرة الجديدة أساسًا في كلِّ كتابة...
وأراني لا أقسِّم الشِّعر أزمنة. لأنَّه واحد مذ كان، وواحدٌ إلى أن ينتهي الدهر. لذا هو الذي يبقى بكل موضوعاته.
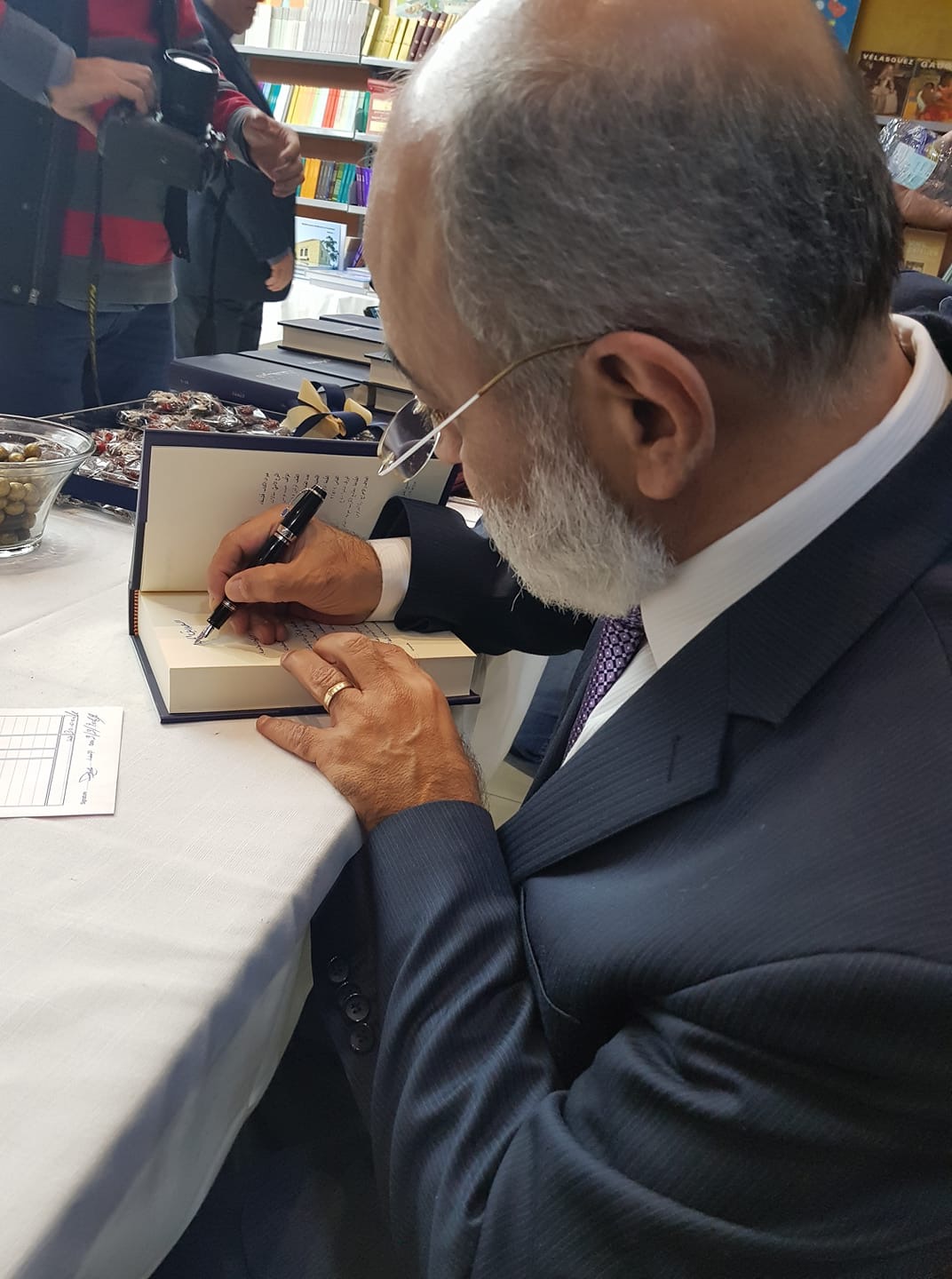 الكاتب موقعًا أحد مؤلفاته
الكاتب موقعًا أحد مؤلفاته
ومن "أكسسوارات" الموت، الغموض. سئلت: هل الغموض في القصيدة يؤدي إلى ابتعاد القراء عنها؟ أجبت: ببساطة، حين يفسِّر لي من يتعمَّد الغموض، غموضه، فأفهمَ قصده، أتفهَّمه، وأقترب من قصيدته. ولكن أظنُّ أن ثمَّة من يلجأ إلى الغموض، ليكذِب على القرَّاء بشاعريَّة زائفة. أقبل الرَّمزيَّة والإيحاء والتَّلميح، أمَّا الغموض فمثل من يدعوك إلى البحث عن حبَّة ملح في محيط...
والسؤال الذي يجذب كثرًا إليه متى أكتب بالفصحى ومتى أكتب بالمحكية؟ وأين أجد نفسي أكثر؟ وجوابي الذي قد يفجأ البعض، ولمن لا يعرف أنَّني بدأت بكتابة الشعر بالفرنسيَّة الَّتي كنت أتقنها أكثرَ من أيِّ لغة أخرى. وكنت ودِدت لو تعلَّمت لغاتِ الأرض جميعًا لأكتب بها. وبما أنَّ عالمي الشِّعريَّ اقتصر على الفصحى والمحكيَّة اللبنانيَّة، وجدتُني أقبِض على مِفتاح، ما همَّني من صنعه. مفتاح هو عبارة عن كلمة أو صورة أو ومضة، يجعل أبواب الكون، بما فيها أبواب الجحيم، ترضخ لمشيئته. أجد نفسي حيث يدور المفتاح.
وبما أن الشِّعر من الفنون السبعة، فلا نتعبنَّ لنحدِّد أيًّا من الفنون يتقدَّم على غيره، ولا سيَّما منها الشعر. وأظنُّ، ردًّا على سؤال كهذا، أنَّ الفنون جميعًا تشبه فرقة موسيقيَّة تعزف لحنًا واحدًا، هو الجمال. وكما هي حال عمل الفرقة، يتقدَّم أحيانًا دور آلة على أخرى. هكذا كانت الحال مذ نشأت الفنون، وتبقى وتستمرّ. يتقدَّم الشِّعر، صحيح. ولكن من قال إن الموسيقى أو الغناء ليسا في المصفِّ نفسه؟ وكذلك النَّحت والرَّسم... فمنصَّات التَّعبير الشِّعريَّة متنوِّعة، بين الكتاب والصحيفة والمجلَّة، على الرَّغم من تراجعها، وكذلك وسائل التَّواصل على كثرتها. تنشر نصًّا وكفى. ولكن هل يمكن إقامة معرض رسم أو نحت، إلَّا في مكان عام؟ أو تقديم مقطوعة موسيقية إلَّا على مسرح أو ضمن مساحة هواء طلق؟
إذا كان الشعر يتقدَّم اليوم، فحين يصفو الجو العام، سنرى الفنون الأخرى قربه في الصَّفِّ الأماميِّ. الإبداع مهما تأخر... جايي.
 ماجدة الرومي بعدما تحدثت في توقيع أحد كتب حبيب يونس، وبدا عن يمينها المطران بولس صياح، وعن يسارها الأب الراحل إيلي كسرواني
ماجدة الرومي بعدما تحدثت في توقيع أحد كتب حبيب يونس، وبدا عن يمينها المطران بولس صياح، وعن يسارها الأب الراحل إيلي كسرواني
ويحلو للبعض أن يحاكي الأزمات الَّتي نعيشها. والسُّؤال هل هناك موضوع أوّل وأولى على الشاعر طرحه؟ وجوابي أن ليست بلادنا من يعيش أزمات، العالم كلُّه يعاني أزمة أخلاق، ويشهد انحدارًا قِيَميًّا خطرًا، لأنَّ صنَّاع القرار، كما يسمَّون، استبدلوا الإله الأخضر بالله. وليس دورُ الشاعر إلَّا أن يكتب، في أيِّ مجال أو موضوع. لا أظنُّني كتبت قصيدة غزل، ومن أحبُّ كانت أمامي أو في حضني. أجمل قصيدة غزل كتبتها في ملجأ، تحت خطر الموت.
قصيدة الشَّاعر ممحاة لنصٍّ شيطانيٍّ يكتبه عَبَدَةُ الإله الأخضر. فلنُكثر من المماحي، ولنُعِدْ صوغَ العالم بأجنحةِ خيالنا.
واستطرادًا للسُّؤال السَّابق، كان الطَّرح أنَّ الشَّاعر - كرسول خير وحقّ وجمال، وكمبشّرٍ بالحريّة الكاملة والإنسانيَّة الشاملة - ينبغي أن يكون قائدًا فكريًّا، لا منقادًا وتابعًا ومتقوقعًا ضمن إطار ضيِّق. فأين أقف شخصيًّا بين مفهومي الحرِّيَّة والالتزام؟ وبالتالي، ماذا سيكون موقفي في حال حدث تعارضٌ بين مبادئي الإنسانيَّة والتزامي السِّياسي؟
أجبت السَّائل يومذاك أنَّني أعتنق مبدأً، أظنُّه للكاردينال ريشليو، يقول: الالتزام قرار حرٌّ لأناس أحرار. لم يضرِبني أحدٌ على يدي، أو يضعْ فوهة المسدَّس في صدغي، ليجبرني على اعتناق خطٍّ سياسيٍّ أو فكريٍّ أو عقائدي. أنا اخترت، وألتزم. وحين أرى خروجًا على مبدأ إنساني أؤمن به، أُعلي الصَّوت ضمن الأطر التَّنظيميَّة، فأصحِّح المسار، أو أترك الزَّمن يظهر صحَّة قولي... ويبقى أن للشَّاعر الَّذي فيَّ، المكانة الأولى.
وذكَّرتني سيِّدة تحبُّ الشِّعر وتكتب الخواطر، بحوار بيننا. قالت لي ذات مرَّة: "القافية تقيِّد"، أجبتُها: "بالعكس القافية تحرِّر". فتحدَّتني أن أَقْنِعها. فقبلت التحدِّي بأن "لا ضرورة لإقناعك في أمر القافية والوزن. هما لا يقيِّدان الشَّاعر إذا كان ابن اللُّغة حقًّا، فتتحوَّل، مهما عصت، عجينةً في يده، ومهما طال أمد العجين والخمير، لا بدَّ يطلع رغيف الخبز، كأنَّه مخبوز في آلة. هنا يكمن السِّرّ. القافية الصَّعبة تجعلك تجهدين ليكتمل المعنى. بمعنى أن تبتعدي عن الكلام المعلَّب، وعمَّا يسمى الإرصاد. وكان الله يحب الشُّعراء لا المستشعرين".
وطرحت السَّيِّدة نفسها سؤالًا عما سمَّته دَفْقًا شعريًّا لافتًا وإنتاجًا غزيرًا مطبوعًا، بلغ 20 مؤلفًا، فما هو سرّي؟ أجبتها، وأنا أتذكَّر عبارة ردَّدها الرَّاحل الكبير موريس عواد على مسمعي عشرات المرَّات "يا إيدي لحّقي ع اللي بيفكر فيه راسي"، أنَّ ما نشرته ما هو إلَّا نزر يسير مما كتبتُ طوال عمري. أنا أشهق وأزفر شعرًا ونثرًا. ولا أحتاج إلى تنفُّس اصطناعي. ما في جَعبتي للنَّشر بعد، من دون أن أدخل في تفاصيل، يربو على ستَّة آلاف صفحة، تضاف إلى مثلها تقريبًا سبق لي أن نشرتها...

 سياسة
سياسة




















