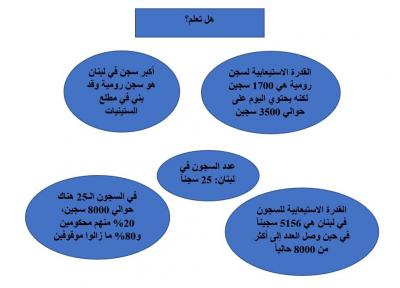أضاء تقرير صادر عن منظّمة الصّحّة العالمية منتصف العام الماضي على ارتفاع معدّل حالات القلق والاكتئاب بواقع 25% خلال عام 2019 وحده. وقد لا يُفاجأ كثيرون إن استمرّت الأرقام بالارتفاع. كيف لا ونحن نعيش على إيقاع عالم ما بعد الجائحة!
ما يقرب من بليون شخص، أكثر من عشرهم من فئة المراهقين على مستوى العالم، تعايشوا ويتعايشون مع تلك الاضطرابات منذ ذلك العام. وكمعدّل، يعيش من يعانون على مستوى الصحة النفسية أقلّ بِعَشر سنوات أو عشرين سنة من أقرانهم "الأصحّاء". أمّا بالنّسبة للتداعيات الاقتصادية، لفتت المنظّمة في تقريرها إلى أكلاف عالية ذات صلة، كتَراجُع الإنتاجية وارتفاع منسوب البطالة. ففي الواقع، تتخطّى الكلفة تلك التريليون دولار سنوياً وقد يرتفع الرقم إلى 3 تريليون دولار بحلول العام 2030.
لذا، يُعدّ فَهْمُ الدّوافع الكامنة خلف تلك الاضطرابات مسألة محورية إذا ما أراد البشر التصدّي الممنهج لها. نترك المنظار الاجتماعي - الاقتصادي وننتقل إلى داخل أروقة المختبرات بحثاً عن إجابات. وإلى اكتشاف "جين القلق"، تحديداً، الذي من شأنه المساعدة في إيجاد علاجات، لا بل في محاولة اجتثاث ما أمكن من مسبّبات الاضطرابات أصلاً.
أدوية كثيرة متاحة يلجأ إليها المصابون تخفيفاً من وطأة الأعراض (ومَن منّا بمنأى تام عنها؟). لكن بما أننا لسنا على دراية كافية بما يدور في أدمغتنا، يمسي وضع التوليفة الأفضل لإنتاج الأدوية الأكثر نجاعة مهمّة شاقة. من هذا المنطلق، قامت مجموعة من الباحثين من جامعتَي بريستول وإكستر البريطانيتين بحجز مجموعة فئران لمدة ست ساعات متواصلة تحفيزاً لها على إطلاق إجابات "قَلِقة" بغية تحليل نشاطها الدماغي على مستوى جزيّئي.
الأمر اللافت في التجربة الحديثة تجلّى بأنها أدّت إلى تزايُد مستويات مجموعة من خمسة جزيئات تُعرَف بالحمض الريبوزي النووي الميكروي أو"microRNAs". وهي جزيئات موجودة أيضاً في الدماغ البشري، ومسؤولة عن تنظيم عدد من البروتينات المستهدَفة التي تتحكّم بالعمليات الخلوية بمنطقة اللوزة الدماغية (Amygdala) والمرتبطة بدورها بمسألة الإجهاد.
وإذ نظر الباحثون بتعمّق إلى الحمض الريبوزي النووي الميكروي الذي وصل إلى أعلى مستوياته بعد تعريض الفئران للإجهاد الحاد، لاحظوا إنتاج كمية متزايدة من نوع واحد من جزيئات الحمض موضوع البحث والمُسمّى"miR483-5p" . هذا في حين نتج عن زيادة منسوب الأخير كَبْتُ التعبير عن جين آخر معروف بـ"Pgap2"، وهو كَبْت يؤدّي بدوره إلى تعزيز عملية الحدّ من القلق.
الحمض آنف الذكر ذات مقدرة استراتيجية على السيطرة على حالات عصبية (Neuropsychiatric) معقدّة كالقلق، بحسب الفريق البحثي. لكن الآليات الجزيّئية الخلوية المستعملة لتفعيل الدفاعات بوجه الإجهاد لا زالت مجهولة إلى حدّ بعيد. ومع ذلك، فنتائج البحث تشكّل خطوة تأسيسية نحو اكتشاف علاجات ثورية لاضطرابات القلق.
نبقى مع الفئران ونتعمّق أكثر. فالقلق، على ما يبدو، لا تدور رحاه في الدماغ حصراً. وبعبارات أخرى، قد يكون القلب هو المنشأ. الشعور بتسارُع دقات القلب لدى التعرّض للقلق أو الإجهاد ليس بالأمر الغريب. لكن هل تساءلتم يوماً ما الذي يحدث أولاً: التسارُع بسبب الخوف أو الخوف بسبب التسارُع؟ الحالتان ممكنتان تقول دراسة جديدة. وهذا يشرّع نافذة أخرى على مزيد من المعلومات.
في التفاصيل، قامت مجموعة من العلماء بتسريع ضربات قلب فئران اصطناعياً، ما أدى إلى تَفاقُم تصرّفاتها ذات النزعة القَلِقة. والتصرّفات تلك جرى لاحقاً السيطرة عليها من خلال "إطفاء" منطقة معيّنة من أدمغة الفئران المستهدَفة. الدراسة، التي نُشرت مؤخّراً في مجلة Nature، أظهرت تسارُع ضربات القلب نتيجة التواجد في سياق محفوف بالمخاطر ما لبث أن تسلَّل أثره إلى دماغ الفئران رافعاً منسوب القلق لديها.
خلال البحث، قام الفريق بتسليط ضوء على قلوب الفئران المعدّلة جينياً لغرض تغيير سرعة ضربات قلبها. بغياب الضوء، سجّل كل منها معدّل 600 ضربة قلب في الدقيقة. وبعد تشغيله، ارتفع المعدّل إلى 900 ضربة في الدقيقة. المفاجأة التي يُبنى عليها هنا تمثّلت بترافُق شعور الفئران بتسارُع ضربات القلب مع إبدائها تصرّفات تُشتمّ منها رائحة القلق.
والحال أن فكرة مساهمة الأحاسيس الجسدية في التأثير على الدماغ إنّما تعود إلى أحد الآباء المؤسّسين لعِلم النفس، الأميركي ويليام جيمس. ففي كتابه "مبادئ عِلم النفس"، تطرّق إلى مسألة اتّباع المشاعر لاختبارات الجسد وليس العكس. ومن الأمثلة على ذلك، شعور أحدنا بالأسف جرّاء البكاء أو بالخوف بسبب الارتجاف.
ملاحظة أخرى في هذا الإطار. فالرابط بين الإشارات التي يطلقها الجسد داخلياً وبين الدماغ يشار إليه بـ"الحس الداخلي" (Interoception)- أي الشعور بالحالة الداخلية للجسم. وهذا يحيلنا إلى علم البصريات الوراثي (Optogenetics). وهو أحد تقنيات علم الأعصاب التي تسمح بالتحكّم بخلايا الدماغ الحيّة عبر استخدام كابلات الألياف الضوئية ومن خلال الجمع بين الهندسة الوراثية والأدوات البصرية. وتجدر الإشارة إلى اعتقاد العلماء بأن لأعضاء حيوية أخرى أثر مماثل على تحريك منسوب القلق صعوداً أو نزولاً. وهذا ما سينكبّون على إثباته في المرحلة المقبلة.
التوصّل إلى فَهْم أفضل للمنابع التي تتحكّم بصحة الفرد النفسية أساسي إذا ما أردنا استنباط العلاجات المناسبة مستقبلاً. قد لا تأتي التجارب الواعدة بأجوبة قاطعة سريعة، لكن تعزيز الوعي وزيادة الاستثمار في ذلك المضمار ملحّ على جميع المستويات. فهل يصلنا الخبر اليقين من استكمال الأبحاث اللاحقة لاكتشاف "جين القلق"، أو من فكّ طلاسم رابط القلق بين القلب (وأعضاء أخرى) وبين الدماغ... أو من تطوّر علمي آخر ما؟
يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
 سياسة
سياسة