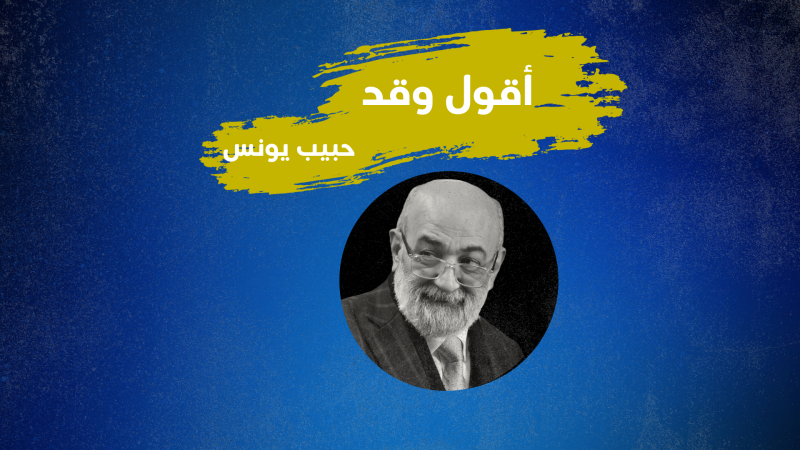هل من الضروري أن أظلَّ أذكر أننا عشية "اليوبيل الذهبي" لاندلاع الحرب في لبنان وعليه، عام 1975؟ أيام تفصلنا عن ذكرى ذاك التاريخ، والشرارة الأولى التي أشعلت حربًا استمرت خمس عشرة سنة، وما زالت مفاعيلها قائمة إلى اليوم.
اندلعت لا لخلاف بين اللبنانيين على السلطة، ولا لمشكلات طائفية ومذهبية، ولا لصراع طبقي، وإن كانت القضايا التي طرحت ضمن هذه الأطر مُحِقّة. اندلعت لتوطين الفلسطينيين في لبنان... ويبدو أن شبح التوطين عاد ليطُلَّ من جديد، في ضوء ما أسفرت عنه تطورات الحرب على غزة وعلى لبنان.
القصة من البداية أنَّ حرب العام 1967 بين إسرائيل والعرب، انتهت بهزيمة عربية سُمِّيت نكسة. تصاعد بعدها العمل الفدائي، خصوصًا في لبنان، وباتت الأحداث المرتبطة به هي الطاغية، وتكثف الجهد الدبلوماسي واقتراحات المشاريع، لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، حتى طلع علينا هنري كيسنجر، وكان مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية، زمن رئاسة ريتشارد نيكسون، عام 1969، بنظرية الشعب الفائض في الشرق الأوسط.
وجد كيسنجر أن إسرائيل محاطة بدول طوق أربع، مصر والأردن وسوريا ولبنان، وأن على أرض فلسطين شعبين إسرائيليًّا وفلسطينيًّا. إذًا ستة شعوب في خمس دول، أي إن هناك شعبًا فائضًا. فاختير الأردن على اعتبار أنَّه الحلقة الأضعف بين الدول الخمس، وأن ثمة وحدة حال فلسطينية – أردنية، ليكون الوطن البديل للفلسطينيين. فاندلعت أحداث أيلول الأسود عام 1970 واستمرت حتى تموز من العام 1971، لتفضي إلى قضاء الملك حسين على فكرة الوطن البديل، وطرد قسم كبير من الفلسطينيين، ولا سيما قياداتهم، وتحديدًا ياسر عرفات، إلى لبنان.
همدت الفكرة قليلًا، لكن الشعب الفائض بقي فائضًا. قرر كيسنجر، وقد تولى وزارة الخارجية، القيام بجولة عربية، بعد حرب تشرين 1973، شملت لبنان، فلم يستقبل في مطار بيروت، خوفًا من تعرضه لاعتداء بفعل انتشار الفصائل الفلسطينية المسلحة في محيط المطار وعلى طريقه، فحطت طائرته في مطار رياق. استنتج ثعلب السياسة الأميركية أن وطنًا لا تستطيع عاصمته استقبال زائر أجنبي، غير جدير بالبقاء. فليكن إذًا لبنان الوطن البديل.
فكرة راقت بعض القيادة الفلسطينية التي أتاح لها اتفاق القاهرة عام 1969، إقامة دولة ضمن الدولة، ليس في الجنوب فحسب، في ما عرف بـ"فتح لاند"، إنما حتى في كل لبنان.
وكانت حادثة بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان 1975، وسنوات من الحرب، انقسم فيها لبنان، و"غطست" فيها الفصائل الفلسطينية حتى أذنيها، وبقي كثر يرددون أنها حرب أهلية. وتوالت عروض، قيل إن أحدها قدّمه موفد كيسنجر، دين براون إلى الرئيس سليمان فرنجية لنقل المسيحيين من لبنان إلى الولايات المتحدة، وبواخر النقل جاهزة. رفض الرئيس فرنجية العرض، لكن مفاعيل الحرب لم تنتهِ، حتى دخلت سوريا لبنان في محاولة لتعزيز موقفها في الصراع، بجمع منظمة التحرير الفلسطينية ولبنان تحت جناحها، بعدما اشتمت قيادتها اتجاهًا لدى أنور السادات لإقامة سلام مع إسرائيل، على أثر مؤتمر عقد في جنيف عام 1975. وتردد أن حرب لبنان اندلعت ليخفي غبارها الخطوة الساداتية نحو إسرائيل، الأمر الذي تحقق في تشرين من العام 1977.
قامت جبهة "الصمود والتصدي" (سوريا، منظمة التحرير، الجزائر، ليبيا، العراق، اليمن)، بدعم من الاتحاد السوفياتي، في إطار الحرب الباردة بينه وبين الولايات المتحدة. خمس سنوات من جولات القتال في لبنان، تطورت خلالها المواجهات إلى ميني حرب إسرائيلية – سورية، مسرحها البقاع اللبناني، في ظل وساطة تولاها الأميركي من أصل لبناني فيليب حبيب، لحل أزمة الصواريخ التي نشرتها سوريا في السهل.
إلى أن أدت التطورات إلى اجتياح إسرائيل لبنان، في ما عرف بحرب "سلامة الجليل"، عام 1982، ما أفضى إلى تدمير قوة منظمة التحرير، وانسحاب الجيش السوري من جزء كبير من لبنان، وترحيل القيادة الفلسطينية إلى تونس... ومن ثم توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق 17 أيار 1983 الذي ألغي عام 1984.
خُيِّل إلى اللبنانيين أن صفحة التوطين، بذلك، قد طُويت. لكن عودة ياسر عرفات المبعد إلى تونس، إلى طرابلس، واشتباك فصائله مع وحدات عسكرية سورية، وترحيله من جديد، ومن ثم قيام حرب المخيمات بين حركة أمل والفصائل الفلسطينية، والأحداث التي شهدها عهد الرئيس أمين الجميل، ولا سيما منها حركة 6 شباط 1984، فحصرت سلطته بمساحة ضيقة... أبقت سيف التوطين مصلتًا على العنق اللبناني.
انتهت الحرب عام 1990، عملًا باتفاق الطائف الذي أُقِرّ عام 1989، وتضمنت مقدمته نصًّا صريحًا برفض التوطين والتقسيم والتجزئة.
وكان مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. شارك فيه لبنان، ودول الطوق وإسرائيل طبعًا، برعاية أميركية. سارت مسارات التفاوض وأفضى اثنان منها إلى اتفاقي أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير، ووادي عربة مع الأردن، وبقي المسار السوري بين أخذ ورد، فيما المسار اللبناني مرتبط به.
وعادت "نغمة" التوطين إلى الواجهة، في ضوء الكلام على عجز أراضي السلطة الفلسطينية عن استيعاب فلسطينيي الشتات، فكان مشروع القريعة في إقليم الخروب لاستضافة ستة آلاف عائلة مهجرة من المخيمات الفلسطينية المدمّرة تتضمن مشاغل خفيفة لتوفير عمل للفلسطينيين، كأنّي به توطين مبطَّن أو مضمَر.
لم تقف الأمور عند هذا الحد، تعددت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مع تصاعد نفوذ "حزب الله" الذي عزز وسائل مقاومته، فكانت حرب تموز 1993، وحرب عناقيد الغضب 1996، وتحرير الجنوب عام 2000، ومن ثم حرب تموز 2006... وإلى الأهداف المعلنة لتلك الحروب، أدرج كثر نفوذ حزب الله، بسلاحه، في خانة رفض التوطين.
وفي ضوء انسداد الأفق على مستوى حل الصراع العربي – الإسرائيلي، وتراجع فكرة قيام الدولتين، جاءت حرب طوفان الأقصى، وحرب الإسناد، لتزيدا الطين بلة. فالتوجه السائد اليوم، بعد الكارثة التي حلّت بغزة ولبنان، هو نقل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر... لأن غزة ستصبح "ريفييرا" الشرق الأوسط. أما السلطة الفلسطينية في رام الله فليس من يأخذ برأيها، والله أعلم ما مصير الضفة الغربية إذا كان المخطط الإسرائيلي يقضي بطرد معظم الفلسطينيين من أرض فلسطين، بمن فيهم عرب 1948.
وفي لبنان... إذا لم يكن الأمر يتعلق بنقل مزيد من الفلسطينيين إليه، فعلى الأقل توطين الموجودين لديه فيه، أضف إليهم دمج النازحين السوريين... وهذا ما لوّحت به منظمات دولية ودول علنًا، وخصّصت له مبالغ مالية ضخمة وجمعيات أهلية... وهذا ما رفضه الرئيس ميشال عون من منبر الأمم المتحدة مرتين. وهذا ما يخُشى أن يعاوَد طرحُه اليوم، في ضوء نتائج حربي طوفان الأقصى والإسناد.
صحيح أن السلطة الجديدة في لبنان، مدعومة عربيًّا ودوليًّا، وتعمل لكي ترسي السلام والأمان وتبني الدولة وتستعيد الثقة... لكن الصحيح أيضًا أن إسرائيل ماضية في طموحاتها التوسعية، والضوء الأخضر الذي أعطي لها، بالدعم السياسي والعسكري والأمني والمالي، خصوصًا من الولايات المتحدة، يبدو أنه سيبقى أخضر إلى أن يرتسم من جديد شكل الشرق الأوسط.
فهل من عود على بدء؟ أي إن ما رفضه اللبنانيون في 13 نيسان 1975، سيفرض عليهم؟ نرجو أن لا.
 سياسة
سياسة